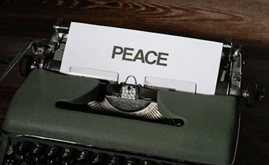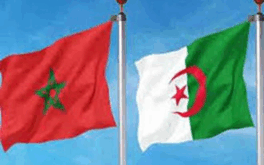الرباط في 29 يوليو 2025
بقلم بسيم الأمجاري
المقدمة
الفرق بين تكريم العبقرية وإهمالها لا يكمن مجرداً في الاعتراف، بل في بنية منظومات اجتماعية وثقافية واقتصادية تُعلي من السطحية وتُقصي الفكر.
ففي مختبرات العالم المتقدّم، يُحتفى بعالم يخترع علاجات أو يكتشف تطورات علمية؛ بينما في بعض المجتمعات المتخلفة، قد يحمل عالم جائزة نوبل، فيبدو أمام العامة كمشهد غريب لا قيمة له إذا لم يقرن بربح المال.
هذه الفجوة ليست صدفة، بل هي انعكاس لمنظومة تقمع العقل الإبداعي، وتُقيم التافهين على أنهم أبطال.
في هذا المقال نُفصّل هذه الظاهرة، نُحقّق في بيانات موضوعية، ونقدّم نموذجاً عملياً للنهوض.
1. صناعة الأبطال الوهميين
في عصر السوشيال ميديا، تحوّلت الفضائيات والمنصات الرقمية إلى مصانع لإنتاج “مشاهير تافهين”، يدرون المال أكثر من العلماء والمختصين.
إحصائية دراسية: تشير إحدى الدراسات أن غالبية الشباب العربي يُفضّلون الشهرة على التخصص العلمي، وهذا يعكس ميل الجمهور إلى المحتوى التافه.
ضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي: ميزانية برنامج تلفزيوني شهير قد تساوي مئات المنح البحثية. وإن كنا لا نملك رقماً دقيقاً، لكن المثال يوضّح تفاوتاً في الأولويات. السبب واضح: “التفاهة ربحيّة” بالنسبة لشركات الإعلام والدعاية، والمدارس التسويقية تفضّل المحتوى الخفيف الذي يدرّ أرباحاً عن المحتوى العلمي.
2. ثقافة «ما رأيك؟» كبديل عن الرأي العلمي
في مجتمعاتنا، يُصبح الرأي الشخصي بديلاً عن الرأي العلمي، حتى في مواضيع تتطلب تخصصاً.
مؤثرون ومدونون يدّعون المعرفة الطبية أو الاقتصادية وفي مختلف التخصصات العلمية بدون مؤهلات. بينما في الدول المتقدمة، مثل اليابان، يحظى العالِم بشعبية كبيرة: محاضرات علماء في الدول المتقدمة قد تُحقّق ملايين المشاهدات عبر الإنترنت ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتناسب مع ثقافة احترام العلم. بينما في الدول المتخلفة مجرد بث مباشر لشجار بين ممثلين أو فضائح قد يحظى بالاهتمام ويجلب 20 مليون مشاهدة.
3. المؤسسة الدينية المغوّرة: تحريم العقل باسم القداسة
في “بعض” التفسيرات الدينية، يُحول السؤال أو الاجتهاد إلى خروج عن الدين أو بدعة، مما يقلص مساحة التفكير النقدي.
أمثلة تاريخية:
ابن رشد: كُتبه حُرقت في العالم الإسلامي، ثم تبنتها أوروبا كأساس للنهضة الغربية.
الحلاج: عُذِّب وصلب لأنه قال “أنا على حق”، فيما تُدرّس أفكاره اليوم في سوربون ومراكز فكرية.
اليوم: بعض الفتاوى لا زالت تعتبر علم النفس بدعة والذكاء الاصطناعي محاكاة للخالق، رغم أن الدراسات العلمية العالمية تؤكد فائدتهما في الطب والتعليم وغيرها.
4. التعليم: مصنع الإذعان بدل الإبداع
النظام التعليمي في المجتمعات المتخلفة يعاقب الطفل الذي يسأل ويكافئ الذي يحفظ دون فهم.
منطق بيئة التعليم:
يُعتبر الطفل السائل “مشاكسا ومشاغباً”، والناقل للمعلومات يُحتفى به ضمن “الممتازين”.
المدارس تُنتج طلاباً قادرين على الحفظ، لكن غير مهيّئين للتساؤل والإبداع.
هجرة العباقرة:
تقديرات تقريبية: نحو 90% من الحاصلين على جوائز عالمية (مثل نوبل أو ميداليات علمية دولية) من العالم العربي، اضطروا للهجرة لأن بيئاتهم لم تحتضنهم ولا يتلقون منها التشجيع الدعم الكافي.
5. السياسة كمُسوِّق للرداءة
في عالم السياسة، يُختار من يُسلي الجمهور، وليس من ينعش الفكر والعقل.
العالم يطالب بالشفافية والمحاسبة، والفنان بالحرية، أما المهرج فهو من يبيع الوهم ويشغل الجمهور.
تتكرر استراتيجية “خبز وسيرك”: بدل حملات تعليمية واضحة، يتم إبراز نجوم الرياضة والفنانين في وسائل الإعلام.
الجمهور المشغول لا يسائل السياسات أو يطالب بالإصلاح، بل يستهلك التفاهة.
6. كيف تنتقل الأمم من التخلف إلى النهضة؟ نموذج كوريا الجنوبية
تحوّلت كوريا الجنوبية خلال حوالي ستة عقود من دولة زراعية إلى قوة صناعية وتقنية عالمية:
في الستينيات، كانت واحدة من أفقر دول العالم، لكنها بدأت بالتنمية الصناعية الموجهة نحو التصدير—عن طريق خطط خمسية (1967–1971، 1972–1976، إلخ) تركَّزت على صناعات استراتيجية مثل الإلكترونيات والسفن والسيارات.
استثمرت الدولة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي في رأس المال الثابت، وصلت إلى نحو 32% من الناتج في 2023 (مقارنة بمتوسط عالمي 23%).
أنفقت حوالي 4–5% من الناتج المحلي على البحث والتطوير، وهي من أعلى النسب عالمياً، وتجاوزت الولايات المتحدة وألمانيا في بعض السنوات.
مصانع “الكايبول” (chaebols) مثل Samsung وSK Hynix تولّت الابتكار والتصدير، واستحوذت على 60% من سوق الذاكرة العالمية لعام 2022، وتقدّم استثمارات ضخمة حتى في 2025 .
النتائج: نمو اقتصادي سنوي أكثر من 8% في عقود محددة؛ الناتج للفرد قفز من حوالي $104 في 1962 إلى أكثر من $5,400 في 1989، ومئات المليارات بحلول الألفية.
من الإعجاب بالنجوم إلى تمكين العقول: خريطة طريق للنهوض الحضاري
لكي تتحول أمة من حال التخلّف والتبعية إلى فاعل في صياغة المستقبل، لا يكفي أن نتذمر من التفاهة المنتشرة أو نرثي واقع العباقرة المُغيبين؛ بل لا بد من خطة واضحة الملامح، متدرجة الخطوات، قابلة للتطبيق، تبدأ من الفكرة وتنتهي بالتنزيل.
1. إعادة تعريف “النموذج القدوة”: من مُستَهلِك للشهرة إلى صانع للقيمة
الإعلام، سواء الرسمي أو الاجتماعي، يلعب الدور الأبرز في صناعة النماذج.
حين يُقدَّم لاعب كرة كمُلهم، وتُهمّش قصة شاب اخترع روبوتًا طبّيًا، فالنظام يوجه اللاوعي الجمعي إلى “من يستحق التشجيع”.
يجب إعادة صياغة الخطاب الإعلامي ليحتفي بالإنجاز المعرفي كما يحتفي بالفوز الكروي. برامج تلفزيونية وثائقية وسرد قصصي لصانعي التغيير مطلوبة، مع مكافآت رمزية ومعنوية تُرسخ قيمة العالِم، لا مجرد ظهوره “لإكمال الديكور” في النشرات.
2. ثورة في النظام التعليمي: من التلقين إلى التفكير
لا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية دون كسر القوالب التعليمية الجامدة. يجب أن يتحول السؤال من “ما هي الإجابة الصحيحة؟” إلى “لماذا نعتقد أن هذه هي الإجابة”؟
المطلوب هو تحويل المدارس إلى مساحات اختبار للعقل، وليس ساحات حفظ. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
- تحديث مناهج العلوم والفلسفة وربطها بواقع الحياة اليومية.
- تدريب المدرسين على مهارات التفكير النقدي لا مجرد تقديم الدروس.
- ربط التلميذ بمشاريع جماعية تُنمّي حس المبادرة والعمل التشاركي، بدلاً من الاختبارات الموحدة القاتلة للتميّز.
3. تشريعات لحماية وتمكين العباقرة
المبدع في عالمنا العربي يُعامَل كـ”شخص غريب الأطوار”، حتى ينجح في الخارج، ثم يُحتفى به بعد فوات الأوان.
يجب إصدار قوانين تشجع الإنتاج العلمي وتحمي حامليه من التحقير أو الإقصاء. مثال:
- إعفاءات ضريبية للمخترعين وأصحاب براءات الاختراع.
- إنشاء صناديق وطنية لتمويل البحث العلمي، لا سيما في مجالات حيوية (الصحة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة).
- حماية قانونية من السخرية الإعلامية، وتجريم “حملات التشويه” ضد العلماء والمفكرين.
4. ربط البحث العلمي بسوق العمل والصناعة
لا قيمة لأي بحث إذا لم يكن قابلاً للتطبيق أو التأثير. لذلك، يجب أن تكون المؤسسات الصناعية شريكًا حقيقيًا للجامعات. في النموذج الكوري الجنوبي أو الفنلندي، تموّل الشركات الكبرى أبحاث الجامعات وتستخدم نتائجها لتطوير منتجات وخدمات.
يمكن للدول العربية أن تبدأ من خلال:
- إنشاء مراكز أبحاث مشتركة بين القطاع الخاص والجامعات.
- تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في حلول تكنولوجية محلية.
- فرض نسب دنيا من أرباح الشركات الكبرى لتمويل البحث والتطوير، كما تفعل دول مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل.
5. توسيع مفهوم “الثقافة العامة” ليشمل العلم والمعرفة
لا ينبغي أن تبقى الثقافة العامة مقتصرة على الشعر والغناء فقط، رغم أهميتهما، بل يجب أن تتسع لتشمل المفاهيم العلمية والفلسفية.
مكتبات عمومية رقمية، مهرجانات للعلوم، أيام مفتوحة للمختبرات، ومسابقات في الابتكار على مستوى المدارس والجامعات؛ كل هذه أدوات بسيطة لكنها فعالة في ترسيخ صورة “العالِم القدوة”.
الإعلام الثقافي يجب أن يتطور ليتحدث بلغة الناس دون تسطيح، ويُبسّط المفاهيم لا أن يُفرغها من مضمونها.
6. إصلاح الذهنية الجمعية: تغيير نظرتنا لأنفسنا
النهوض لا يبدأ من السياسات فقط، بل من “النظرة إلى الذات”.
علينا أن نُربّي الأطفال منذ الصغر على فكرة أن قيمة الإنسان فيما يُنتجه من معرفة وعطاء، لا في عدد متابعيه أو مظهره.
الثقافة الأسرية والمدرسية والدينية يجب أن تزرع في النفوس أن “من يطرح الأسئلة هو الذي يغيّر العالم”، وأن العقل ليس خصمًا للقداسة، بل طريقًا إليها.
خاتمة: بين التقديس الزائف والتهميش المُمنهج… هل نملك الشجاعة لننهض؟
التاريخ لا يتذكر أسماء أولئك الذين ملأوا الشاشات ضجيجًا، بل يخلّد أولئك الذين أناروا العقول وأسسوا للفكر. إن مأساة مجتمعاتنا ليست فقط في أنها تُهمل العباقرة، بل في أنها تُعاديهم، وتُكرّم من يناقضهم في القيمة والعمق.
لقد وصلنا إلى مفترق طرق: إما أن نستمر في استهلاك إنتاج غيرنا ونُغرق أنفسنا في التفاهة، أو أن نراجع منظومتنا الأخلاقية والتربوية والإعلامية، فنُعيد الاعتبار للعقل، ونجعل من المبدع بطلاً، لا ضيفًا ثقيلًا يُستضاف لمجرد التوازن في البرنامج.
نحتاج إلى شجاعة حضارية—تتجاوز ردود الأفعال والشعارات، نحو حركة نهضوية تُعيد توزيع القيمة في المجتمع: من الجعجعة إلى الفكرة، من التهريج إلى التفكير، من التبعية إلى السيادة المعرفية.
إن أخطر ما تواجهه الأمم ليس الجهل، بل الرضا بالجهل وتجميله. وإن أعتى أشكال التخلف ليست المادية منها، بل تلك التي تحجب النور وتقدّم الظلام على أنه نور آخر.
للاطلاع على مقالات أخرى، يرجى النقر على رابط المدونة https://moustajadat.com
 Moustajadat
Moustajadat