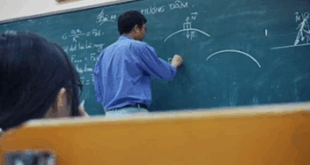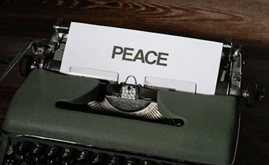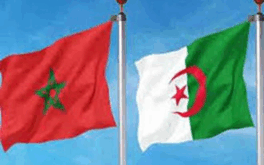بقلم بسيم الأمجاري
في عصر يُفترض أنه عصر المعرفة والانفتاح على العالم، باتت الكلمة المكتوبة تعاني من عزلةٍ قاسية، وغدت القراءة، التي شكّلت يومًا سلاحًا للوعي والتغيير، في موقع الهزيمة أمام سطوة الصورة والفيديو السريع. والمفارقة المقلقة أن هذا التراجع لم يأتِ نتيجة تطور بديل أرقى، بل جاء في ظل تنامٍ مخيف لمحتوى سطحيّ ومُفرغ من القيم، اجتذب انتباه الجماهير وأخذ من وقتهم أكثر مما يستحق.
فيديوهات الرداءة – تلك المقاطع القصيرة المليئة بالصراخ، والضحك المبتذل، والتحديات السخيفة – أصبحت اليوم هي المادة الأكثر رواجًا عبر منصات التواصل، والأكثر قدرة على حصد التفاعلات والإعجابات، حتى وإن كانت تفتقر لأي قيمة معرفية أو جمالية. وبالمقابل، أصبح المقال العميق، أو الكتاب الجاد، يئنّ وحيدًا في ركن مظلم من الشبكة، لا يقترب منه إلا قلة قليلة من النخبة أو المثقفين الذين ما زالوا متمسكين بشغفهم المعرفي.
من التلقي البصري إلى الانفصال عن النص
أحد أبرز سمات هذا العصر هو تحوّل الإنسان إلى كائن بصري بالدرجة الأولى. لم تعد القراءة وسيلته المفضلة لاكتساب المعرفة، بل أصبح يفضل الاستماع أو المشاهدة. وفي الوقت الذي تسير فيه مجتمعات مثل اليابان وألمانيا وفرنسا نحو المزيد من تشجيع القراءة – حيث تُشاهد الركّاب في القطارات والحافلات وهم يتنقلون بين صفحات الكتب – نجد أن كثيرًا من المجتمعات العربية، وللأسف، قد انساقت خلف محتويات تافهة لا تصنع وعيًا ولا تعزز مهارات التفكير.
ويزداد الأمر خطورة حين نلاحظ أن هذا التراجع لا يقتصر على الفئات الشعبية أو محدودة التعليم، بل يشمل أيضًا شرائح النخبة: أطباء، مهندسون، أساتذة جامعيون، بل حتى حملة الشهادات العليا، ممن بات بعضهم يعجز عن التعبير بلغة سليمة، أو كتابة فقرة متماسكة، أو تقديم فكرة واضحة بلغة منسجمة مع تخصصه.
لماذا أصبحت الرداءة أكثر جاذبية؟
لعل السؤال الجوهري هنا هو: ما الذي يجعل الرداءة أكثر جاذبية من العمق؟ يمكن تلخيص الإجابة في النقاط التالية:
- السرعة والإشباع اللحظي: الفيديوهات الرديئة لا تتطلب جهدًا أو وقتًا، تقدم “ضحكة جاهزة” خلال ثوانٍ. وهذا يناسب عقلية “المستهلك الرقمي” الذي لم يعد يملك صبرًا للغوص في نص طويل.
- السهولة على الدماغ: المشاهدة السطحية لا تتطلب التفكير النقدي أو التحليل، وهي بذلك تلائم الأدمغة المُنهَكة من ضغوط الحياة اليومية، على عكس القراءة التي تتطلب تركيزًا وعملاً عقليًا متواصلاً.
- منصات التواصل كمسرّع للسطحية: الخوارزميات تُكافئ التفاعل السريع، وكل ما هو مثير أو صادم أو غريب يجد طريقه إلى ملايين المتابعين. بينما المحتوى الهادف، إن لم يكن مصحوبًا بوسائل جذب ذكية، يضيع في الزحام.
- التحول في منظومة القيم: لم تعد الثقافة تُقاس بالمعرفة أو الإنتاج الفكري، بل بعدد المتابعين والمشاهدات. هكذا يصبح “اليوتيوبر” صاحب التحديات السخيفة نجمًا جماهيريًا، بينما يغدو كاتب الرواية أو الباحث الأكاديمي مجهولًا.
تأثير هذا التراجع في مستقبل المجتمعات وأجيال المستقبل
تراجع ثقافة القراءة لا يُعدّ أزمة تخص النخبة الثقافية وحدها، بل هو ناقوس خطر يقرع أبواب المجتمعات بأسرها، لأنه يُفرغ الإنسان من أهم أدوات الوعي والنقد والتحليل. حينما تتلاشى القراءة من الحياة اليومية، تبدأ أولى ملامح الضعف الحضاري في الظهور، لا في البنية التحتية أو الاقتصاد فحسب، بل في بنية العقل الجمعي ذاته.
المجتمع الذي لا يقرأ، يُنتج أفرادًا غير قادرين على التمييز بين المعلومة الصحيحة والزائفة، بين الفكرة المتماسكة والدعاية المضلّلة. يفقد القدرة على التفكير المستقل، ويصبح فريسة سهلة لأي سلطة إعلامية أو سياسية تُحسن استخدام الصورة والصوت للتأثير في العقول. وفي مثل هذا السياق، لا تعود الديمقراطية قائمة على وعي المواطن، بل على انفعالاته الآنية، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس العدالة والحكم الرشيد.
أما على مستوى الأفراد، فالأجيال التي تنشأ في ظل طغيان “السطحية الرقمية” تعاني من ضعف في المهارات التعبيرية، والعجز عن صياغة فكرة، أو كتابة نص منطقي، أو الدفاع عن وجهة نظر. لا يعود الذكاء مرتبطًا بالتحليل والاستنباط، بل بالقدرة على جذب الانتباه على “تيك توك” أو “ريلز”. هذه الأجيال، رغم إتقانها لاستخدام التكنولوجيا، تفتقر إلى العمق اللازم لفهم تعقيدات العالم من حولها، وهو ما يضعف قدرتها لاحقًا على القيادة والإبداع والمشاركة الفعّالة في بناء المستقبل.
ولعلّ أخطر ما في الأمر هو أن هذا التراجع المعرفي لا يظهر سريعًا كما في الانهيارات الاقتصادية، بل يتراكم بصمت عبر سنوات، حتى نجد أنفسنا أمام مجتمع يحمل شهادات، لكنه يفتقر إلى أفكار؛ يستهلك المنتجات ولا يصنعها؛ يُقلّد دون أن يبدع؛ وينفعل دون أن يحلل.
أين الخلل؟ وهل فقدنا المعركة؟
قد يكون من السهل تحميل المسؤولية للفرد وحده، واتهامه بالكسل أو غياب الوعي، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا. الخلل يبدأ من منظومة متكاملة، تشترك فيها مؤسسات التعليم، والإعلام، والأسرة، وصنّاع السياسات الثقافية.
في المدرسة، تُقدَّم القراءة غالبًا كواجب ثقيل لا يحمل لذة أو شغفًا، وتُفرض نصوص قديمة بلغة جافة دون ربطها بحياة التلميذ اليومية. فلا عجب أن يكبر وهو يرى الكتاب عقوبة، لا مغامرة.
في البيت، نادراً ما يرى الطفل والدَيه يقرؤون. فالقدوة الغائبة تُضعف حماسه وتُفقده الشعور بأن القراءة سلوك طبيعي. وفي الإعلام، تسود موجات الترفيه المستهلك، ويتراجع الاهتمام بالمحتوى الثقافي الذي يُقدَّم غالبًا بصورة مملّة أو نُخبوية لا تُراعي الوسائط الحديثة.
أما على مستوى الدولة، فقلة الدعم الحقيقي للمؤلفين والمكتبات العامة، وغياب استراتيجيات وطنية حقيقية لنشر الثقافة القرائية، يجعل الأمر يبدو كما لو أن الكتاب لم يعد أولوية.
لكن، رغم هذا الواقع المظلم، لا يمكن الجزم بأن المعركة خُسرت نهائيًا. فثمة مبادرات فردية ومجتمعية تنهض يومًا بعد يوم لتعيد للقراءة مكانتها، من أندية كتب افتراضية على “إنستغرام”، إلى منصات رقمية تُلخّص الكتب بأسلوب مشوّق، ومكتبات متنقلة في الأحياء المهمشة.
المعركة ليست سهلة، ولكنها لم تُحسم بعد. فكل قارئ جديد هو جندي في هذه المعركة، وكل كتاب يُهدى لطفل هو بذرة أمل في تربة المستقبل. ما نحتاجه هو أن تتحوّل القراءة من واجب إلى عادة، ومن مشروع نخبة إلى طقس يومي لكل فرد. فقط حينها، يمكن للكلمة أن تنتصر من جديد.
ما الحل؟ وهل من طريق لاستعادة الكلمة؟
إنقاذ ثقافة القراءة لا يتطلب فقط خطابات وعظية، بل سياسات عملية ومسارات ذكية. وهنا بعض المقترحات:
- دمج القراءة في الحياة اليومية: عبر مبادرات تشجع الناس على القراءة في الأماكن العامة، مثل المترو أو الحدائق أو المقاهي.
- مكافأة الإنتاج المعرفي: عبر منح جوائز وقنوات دعم للمحتوى الجاد الذي يُقدّم بأسلوب جذاب ومُبسط.
- دمج التكنولوجيا لصالح المعرفة: عبر إنتاج فيديوهات قصيرة ومؤثرة تُقدم خلاصات كتب أو مقالات عميقة بأسلوب بصري يشد انتباه الجمهور.
- تعليم مهارات التفكير النقدي منذ الصغر: حتى لا يصبح الطفل فريسة سهلة للفيديوهات السطحية أو الأخبار الزائفة.
- تحفيز المؤثرين الجدد على تبني رسائل ذات قيمة: فـ”اليوتيوبر” اليوم يملك تأثيرًا يفوق تأثير المعلم في الفصل، وإن تمكنا من إشراكه في إنتاج المعرفة، فقد نعيد التوازن للفضاء الرقمي.
في الختام: هل يعود المجد للكلمة؟
قد يبدو المستقبل قاتمًا في ظل كل هذه المؤشرات، لكن الأمل ما زال قائمًا. إذ تُثبت لنا تجارب في دول مثل فنلندا وكوريا الجنوبية أن السياسات الواعية والتعليم الذكي قادران على إحياء الشغف بالقراءة. كما أن المبادرات الفردية، من معلمين ومثقفين وكتّاب، تظل شموعًا مضيئة في هذا الظلام.
إن المعركة بين التفاهة والمعرفة ليست جديدة، لكن في هذا العصر الرقمي المتسارع، باتت أكثر تعقيدًا وأشدّ وطأة. لذلك فإن الحفاظ على قيمة الكلمة مسؤولية جماعية، تبدأ من الأسرة، وتصل إلى الإعلام والمدرسة والدولة. وربما آن الأوان لنتوقف ونسأل أنفسنا: أي إرث نريد تركه لأبنائنا؟ وهل نرضى أن يكبروا في عالم لا يعرف للكتاب وزنًا، ولا للكلمة احترامًا؟
أما على مستوى الأفراد، فالأجيال التي تنشأ في ظل طغيان “السطحية الرقمية” تعاني من ضعف في المهارات التعبيرية، والعجز عن صياغة فكرة، أو كتابة نص منطقي، أو الدفاع عن وجهة نظر. لا يعود الذكاء مرتبطًا بالتحليل والاستنباط، بل بالقدرة على جذب الانتباه على “تيك توك” أو “ريلز”. هذه الأجيال، رغم إتقانها لاستخدام التكنولوجيا، تفتقر إلى العمق اللازم لفهم تعقيدات العالم من حولها، وهو ما يضعف قدرتها لاحقًا على القيادة والإبداع والمشاركة الفعّالة في بناء المستقبل.
ولعلّ أخطر ما في الأمر هو أن هذا التراجع المعرفي لا يظهر سريعًا كما في الانهيارات الاقتصادية، بل يتراكم بصمت عبر سنوات، حتى نجد أنفسنا أمام مجتمع يحمل شهادات، لكنه يفتقر إلى أفكار؛ يستهلك المنتجات ولا يصنعها؛ يُقلّد دون أن يبدع؛ وينفعل دون أن يحلل.
للاطلاع على قضايا أخرى، يُرجى النقر على رابط المدونة https://moustajadat.com
 Moustajadat
Moustajadat