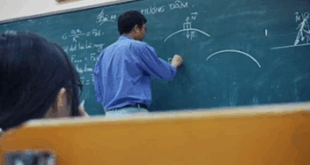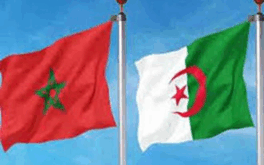بقلم بسيم الأمجاري
مقدمة: دمعة واحدة لا تكفي
في عالم يفيض بالمآسي والصراعات، لا تزال المشاعر الإنسانية المشتركة هي الخيط الوحيد الذي يربط بين البشر جميعاً، مهما اختلفت ألوانهم، لغاتهم، أو أديانهم. مشهد عناق جندي أمريكي لطفله بعد غياب طويل، أو بكاء أم أوروبية تحتضن ابنها العائد من رحلة علاجية، لا يترك أحداً إلا ويؤثر فيه، حتى لو لم يكن من نفس الثقافة أو القومية. لكن، في المقابل، لماذا لا تثير صور أطفال غزة تحت الأنقاض، أو صرخات أمهات سوريا والعراق، نفس القدر من التعاطف العالمي؟ لماذا لا يحرك العالم ساكنا حين يستهدف الصحفي عنوة في فلسطين وهو يؤدي واجبه المهني، أو الطبيب وهو يقوم بدور إنساني لإسعاف المصابين والجرحى؟ أين تختبئ المشاعر عندما يُقصف بيت في مخيم فلسطيني؟ ولماذا تُعطى دموع البعض أولوية، بينما تُعامل مآسي آخرين وكأنها أرقام في نشرة الأخبار؟
أولاً: الإنسان إنسان… لكن ليس دائماً
من البديهي أن الإنسان، أي إنسان، مهما كانت خلفيته، يفرح، يحزن، يشتاق، ويتألم بنفس الطريقة. الأمهات في نيويورك كما في غزة، يعانين ذات اللوعة حين يغيب الأبناء أو يُسلبون. الأطفال في باريس أو في بغداد، يبكون من الخوف ويصرخون حين يسمعون دوي الانفجارات. لكن المشكلة لا تكمن في وجود أو غياب هذه المشاعر، بل في طريقة تمثيلها وتلقيها على المستوى الإعلامي والسياسي، وربما الأهم: على مستوى الضمير الإنساني العالمي.
المفارقة العجيبة أن المنظومة العالمية، سواء عبر الإعلام أو السياسات، تعامل “الإنسانية” كسلعة قابلة للتجزئة. مشهد اللقاء العاطفي بين أبٍ عاد من الخدمة في الجيش الأمريكي وابنته الصغيرة ينتشر كالنار في الهشيم، يحصد ملايين المشاهدات والتعليقات، ويُقدم كأيقونة للحنان والبطولة. بينما لا تتصدر صورة أم فلسطينية تنتحب فوق جثة طفلها، أي منصة إعلامية دولية، ولا تجد طريقاً إلى الصفحات الأولى في الصحف.
ثانياً: الإعلام وصناعة التفوق العاطفي
تلعب وسائل الإعلام دوراً محورياً في تشكيل الوجدان الجماعي. الإعلام الغربي، على وجه الخصوص، يمتلك أدوات ضخمة لصناعة السرديات التي تُظهر بعض الشعوب كضحايا “حقيقيين”، وتُصوّر آخرين كأرقام، أو في أسوأ الأحوال، كمصدر تهديد أو فوضى. فحين يتعرض الغرب لهجمات أو كوارث، تُسلط الأضواء وتُجند التغطيات وتُفتح منصات التضامن. أما حين يُقصف مخيم للاجئين الفلسطينيين، أو تُباد قرية في سوريا أو لبنان أو غيرها، تمر التغطية على استحياء، وتُسرد ببرودة، وكأن الموت هناك أقل وزناً أو شأناً.
هذه الانتقائية لا تقتصر على التغطية، بل تمتد إلى اللغة المستخدمة. إذ نرى توصيف القتلى في أوكرانيا، مثلاً، بـ”الضحايا المدنيين”، بينما يُستخدم مصطلح “مسلحين” أو “إرهابيين” في وصف ضحايا الغارات في غزة أو العراق، حتى إن كانوا أطفالاً أو نساء، أو مدرسين أو صحفيين أو طاقم طبي، ما يؤدي إلى تشويه الوعي العام، ويُرسخ في لاوعي المتلقي أن ثمة أرواحاً أغلى من أخرى.
ثالثاً: ازدواجية المعايير في السياسة الدولية
لا يمكن الحديث عن الفروقات في الاستجابة الإنسانية دون التطرق إلى السياسات الدولية. فحين تُهاجم أوكرانيا، تهب الدول الكبرى بالدعم العسكري والاقتصادي والإنساني، وتُفتح الأبواب للاجئين، وتُعقد القمم الطارئة. لكن في حالة فلسطين، يستمر الاحتلال منذ عقود، وتُمنع حتى البيانات التي تُدين المجازر تحت ذريعة “حق الدفاع عن النفس”. أليست هذه جريمة إنسانية مكتملة الأركان؟ لماذا لا تُعامل صرخة أم فلسطينية بالقدر نفسه من التعاطف الذي نراه مع أم أميركية تفقد ابنها في إطلاق نار محلي؟
الازدواجية في التعاطي مع الأزمات ليست محض صدفة، بل هي نتاج بنية عالمية منحازة، ترى الإنسان بحسب موقعه الجغرافي والسياسي، لا بحسب جوهره الإنساني.
رابعاً: الطفل هو الطفل… مهما كان اسمه
حين يموت طفل في بروكسل أو في تل أبيب، تنهار المؤسسات الإعلامية، وتُضاء المعالم العالمية، ويغرق العالم في لحظة حداد جماعي. لكن ماذا عن الطفل الفلسطيني الذي يُنتزع من تحت الركام؟ أو ذاك الذي يغرق في البحر هرباً من الحرب؟ هل دموع أمه أقل حدة؟ هل وجعه أقل عمقاً؟ إن تعاطفنا المشروط يُشكل جريمة أخلاقية بحد ذاته.
في الواقع، هذه المفارقة المؤلمة تستوجب التوقف. لأنها تُضعف فكرة الإنسانية المشتركة، وتُفرغها من معناها الحقيقي. فإذا كنا لا نستطيع أن نشعر بنفس اللوعة تجاه ضحايا الحروب أينما كانوا، فنحن لا نتحدث عن “إنسانية”، بل عن تحيّز حضاري خطير.
خامساً: ماذا نقول لأطفالنا؟
في ظل هذه الفروقات الصارخة، يطرح سؤال نفسه بقوة: ماذا نقول لأطفالنا حين يسألوننا لماذا لا يبكي أحد حين يُقتل أطفال غزة؟ ماذا نقول حين يرون العالم ينهض لأجل طفل أوروبي تاه في الغابة، لكنه يصمت أمام مذبحة في رفح أو غزة؟ هل نعلمهم أن بعض الأرواح تستحق الحياة أكثر من غيرها؟ أم نعلمهم أن الكاميرات فقط هي من تُحدد من هو الإنسان؟
إذا أردنا أن نربي جيلاً يؤمن بالسلام، فعلينا أولاً أن نعلمه أن الحياة لا تُقدّر باللون أو الجنسية أو الديانة. وأن الطفل هو طفل، سواء وُلد في جنين أو في بروكلين (إحدى البلدات الخمس في نيويورك).
سادساً: من أجل سلام حقيقي
إن الحديث عن السلام لن يكون ذا معنى إذا لم يكن شاملاً للجميع. سلام لا يستثني أحداً، ولا يُقيّم الألم بناءً على موقعه الجغرافي. فالسلام الحقيقي يبدأ حين نعترف بأن كل أمّ تبكي على طفلها الميت هي أمّا لنا، وأن كل بيت يُهدم هو بيتنا، وكل صرخة خوف في الليل من طفل هو واجبنا الأخلاقي أن نسمعها.
لذلك، الرسالة هنا ليست سياسية بقدر ما هي إنسانية. دعونا لا ننتظر أن تكون المأساة في شوارعنا كي نشعر بها. دعونا نتعلم أن نرى في الطفل الفلسطيني ذات البراءة التي نراها في طفل من شيكاغو. وأن نُعيد تعريف “الإنسانية” بحيث تشمل كل البشر، لا فقط من يشاركوننا اللغة أو العرق أو الانتماء السياسي.
خاتمة: بكاء واحد لا يكفي
ما أحوج العالم اليوم إلى لحظة صدق مع الذات. لحظة نكفّ فيها عن انتقاء مشاعرنا، ونوسّع دائرة تعاطفنا لتشمل كل المتألمين، بلا شروط ولا انحيازات. لحظة نقول فيها إن دموع أمٍ فلسطينية تستحق أن تُعرض في الأخبار، كما تُعرض دموع أمٍ أوروبية. وإن كلّ من يئنّ تحت الحرب يستحق أن يُنصت إليه، لا أن يُنسى.
السلام لا يأتي من مؤتمرات، بل من قلب يُدرك أن “الآخر” هو “أنا” في مرآة مختلفة. وكلّما أسرعنا في هذا الإدراك، قلّت الحروب، وزادت اللحظات التي تبكينا بفرح لقاء أو نجاح، لا بفقدان قريب أو عزيز أو تهجيره.
للاطلاع على قضايا أخرى، يمكن النقر على رابط المدونة https://moustajadat.com
 Moustajadat
Moustajadat